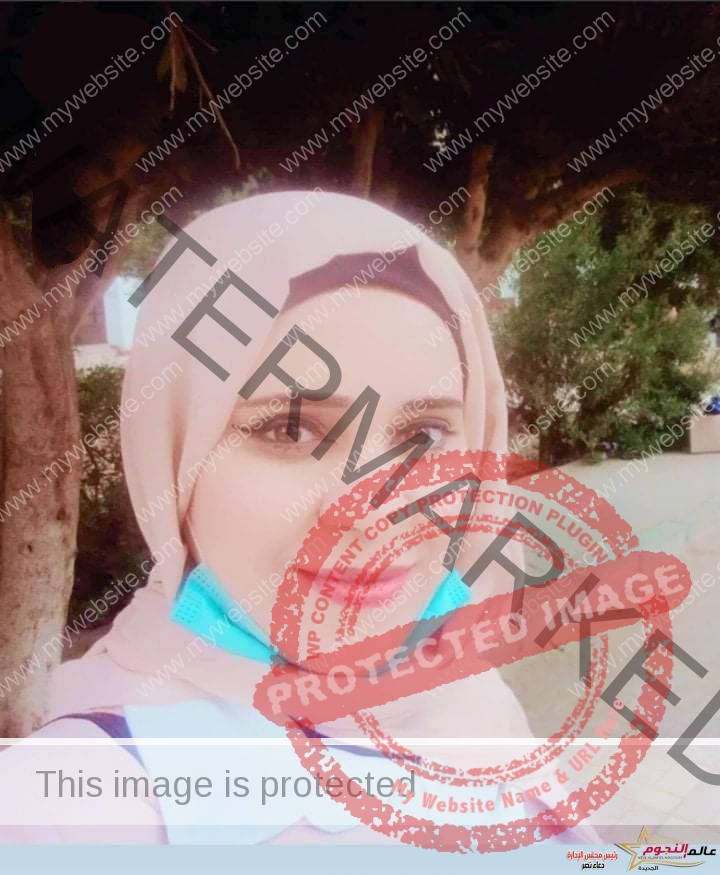قصة قصيرة { طِيبة.. وعثاء الطريق } بقلم: صفاء عبد الصبور

على أول الطريق الخاوى من البشر جلست أطالع ذاك الصبى الآبق الذى ندهته النداهة فولى مدبرًا ثم عاد كهل.
أراه هناك يلهو بثوبه القصير البالى وقدميه الحافيتين حيث تتهادى بخفة الأحلام، لا يُزاحمها شئ سوى رهطٍ من الطيور والدواب وصوت هدير الماء وترنح الأشجار بسبب الريح الثائر وهديل الحمام وقت الشفق كأنما أروع لوحة وأعذب سيمفونية تُعزف وكأنما طِيبة هى جنة الله علي الأرض. هكذا كانت الأيام هناك حيث السكينة والطمأنينة.
يا لها من مُضغة بداخل صدرى تأبي إلا أن تجعل روحى معلقة بذكريات الصبا.
ثمة تصدع بداخلى حدث وكأنما أنا شخص له شخصيتين أحدهما نسخة قديمة والأخرى لشخص يتصنع ويتكلف طيلة الوقت كى يجد لنفسه مكانًا بين أناس لا يشبهونه. كل ذلك جعل قلبى منهك كثيرًا لا يجد الراحة والسلام إلا فى موطنه الأصلى، يا له من شوقٍ عارم لتلك البقعة التى تأبي الروح إلا أن تودع الدنيا منها و من داخل منزل “فاطمة” حيث آثرها ولمستها الحانية وروحها العطرة التى تملأ كل ركن فيه بعد رحيلها.
“فاطمة” جدتى الحانية الحكيمة الجنية المسحورة الزعيمة، الرجل فى جسد إمرأة، صانعة الرجال.
أجل! أنا صنيعتها، “فاطمة” هى من أنعمت عليا بكل شئ.. آوتنى من خوفٍ وأطعمتنى من جوعٍ و حاكت من عمرها رداء الستر والعزة لى، أغدقت عليا بالحنان والحب والدفء ومنحتنى فرصة للحياة وللعلم بعد أن رحلت أمى وتركنى أبى فكانت لى كل شئ.
“فاطمة” الأمية كانت تُوقن بأن العلم هو الملاذ الآمن لشقى يتيم مثلى فما كان منها سوى أن وقفت فى وجه أخوالى الذين علمت أنهم كانوا يضمرون بداخلهم الحقد والكراهية لى بعد أن أرسلتنى إلى المدرسة لألتحق بالصف الأول الإبتدائي دونًا عن أحفادها ولم تستمع لهمسهم فى أذنها بأن تدعنى دون تعليم كى أعمل معهم فى الأرض وفى رعى الماشية وإطعامها وتنظيف الحظيرة كمثل أبنائهم وتوفر نفقات التعليم الباهظة.
قالت لهم بحزم “هاشم” وُلد ليكون شيئًا آخر وليس على شاكلتكم.
كانت ذات شخصية قوية صارمة وعطوفة فى ذات الحين وكانت ذات جمال غير مألوف، فارعة الطول ووجها خمرى وعيناها واسعة عسلية اللون وشعرها طويل مموج ذهبى، كنت لا أراه إلا خِلسةً عندما كانت تمشطه فى الظهيرة فينعكس عليه ضوء الشمس فيصير ذهبي اللون وينعكس على عينيها فتصير كجوهرتين تلمعان فى وضح النهار، ثم تضفر شعرها الكثيف المنسدل أسفل ظهرها ثم تدسه تحت خمارها الأسود وجلبابها الأسود حيث ذلك هو اللون الذي اتخذته أليفًا لها ولم تعرف للملابس الملونة سبيلًا ولا كحل العين منذ وفاة زوجها وهى فى سن السادسة والعشرين فدفنت جمالها وأنوثتها وتعاملت كرجل شأنها كشأن كل أرملة صعيدية، حتى كبر أبنائها وزوجتهم وصار لها أحفاد، بعد الكثير والكثير من الليال الخاوية و الخوف والدموع فى جوف الليل والمصاعب التى واجهتها بالرضا والجلد والتوشح بصفات الرجال حتى لا يطمع الذى فى قلبه مرض.. كان لها بندقية تضعها تحت الوسادة وكانت تدير شؤون الأرض التى كانت عبارة عن ثلاث قراريط والماشية والتى كانت عبارة عن ( بقرة واثنين من الماعز وجدى) وعدد لا بأس به من الطيور والأرانب.
فكانت تستيقظ عند الفجر فتحلب وتعجن وتُشعل التنور وتخبز وتوقد( الكانون) وتطعم الكبير والصغير فى المنزل ثم الماشية والطيور ثم تستأنف أعمالها المنزلية وتعد الغداء وبعد ذلك تدس فى التنور الذى لا يزال يحتفظ بحرارته قدر الفول للعشاء، وفى المساء كانت تخلد للمكوث مع ذاتها تُطالع السماء وتدع الهواء البارد يغسل صدرها المحترق فى صمت وسكون حتى يغلبها النعاس فتستلقى لتريح جسدها. كانت لا تتوانى عن تلك المهام حتى توفت وهى بكامل لياقتها البدنية وبجمالها الساحر المتوارى تحت ركام من الأحزان والغلظة المصطنعة. وحتى الآن لا أعرف ما السر وراء عدم إصابتها بأى مرض من الأمراض المزمنة أو أمراض الشيخوخة ووهنها وما السر وراء أن شعرها وأسنانها حتى آخر عمرها ظلت كما هى فقط لون الشعر تغير إلى الرمادى ولكن ظلت كثافته وطوله وظلت أسنانها بيضاء مستقرة فى مكانها كما هى. كانت تعرف الحسابات وإيراد المحاصيل وتُسعف المحموم وتنقذ المريض والجريح بوصفات وأشياء بدائية وتحفظ قدر من القرآن والأحاديث وتعرف أسماء الرؤساء وبعض من أمور السياسة.. كانت تعرف كل شئ رغم أنها لم تكن سوى إمرأة أمية لكنها حتمًا كانت جنية مسحورة قادرة وواعية تواجه الحياة بمفردها بلا زوج ولا أب ولا إخوة، كانت وحيدة فى الحياة بكل ما تعنيه الكلمة، رغم ذلك صنعت خمس رجال وثلاث سيدات و الكثير من الأحفاد الذين كان بيت “فاطمة” ملاذهم الآمن ومرتعهم الجميل..
وصنعتنى أنا أحد أهم الجراحين فى العالم مدللهما وابن عمرها كما كانت تنعتنى دائمًا الذى تنبأت له بالتفوق فأنفقت من أجله المال والوقت والإيمان الشديد به الذي دفعه لأن يؤمن هو بنفسه أيضًا ويصدق أنه يستطيع أن يتعاطى العلم ويتخطى الفقر والجهل واليتم والهوان ويحقق أهم إنجازات علمية ويتنقل بين الدول الأوربية ويأكل أشهى الأطعمة ويرتدي أفضل الثياب و يجيد اللغات والمهارات؛ لكن شيئًا واحدًا ما كان يجيده لكنته، نعم فلقد حاولت كثيرًا أن أبدل لكنتى وأتحدث مثل أهل القاهرة فتفشل محاولاتى وأجد لهجتى غريبة لا يألفها الناس ولا هى بلهجة صعيدية ولا بلهجة قاهرية حتى تيقنت أنه لا مناص من أن أفخر بلهجتى الصعيدية وأتحدث بها دون الحاجة إلى تغييرها.
وسُرق عمرى بين الطب والأبحاث وحياة المدينة الجوفاء الصاخبة حتى صرت اليوم كهل يكتشف أنه ما عاش وما اغتنم من الحياة شئ سوى العناء والركد والضغوط النفسية، واليوم أود أن أجد الراحة المفقودة هنا فى منزل فاطمة الذى لم يتغير ككل شئ فها هو ظل كقطعة أثرية كبقية الآثار التى تزخر بها محافظة الأقصر.. تفوح منها رائحة العبق وسحر الماضى وشاهدة على سيرة سيدة عظيمة قدمت نموذجًا للأم والجدة القوية القادرة التى قدمت رجال ونساء سويين بعيدًا عن كل المصطلحات الرنانة التى أسمعها الآن عن المرأة القوية.
آآآه..آآآه يا طِيبة! وآآآآه يا فاطمة! قلبى لم يكن مستقر وأنا بعيد عن الأرض التىعن الأرض التى خرجت من طينها وقريتى التى نزحت منها، وأشعر أننى بحاجة الآن من وعثاء الطريق الذي قطعته لبلوغ آمالى الواسعة فكان شاقًا مُنهكًا وما وجدتنى سوى ظمآن يلهث خلف بريق المدينة الكاذب.
فهل حان موعد الراحة؟